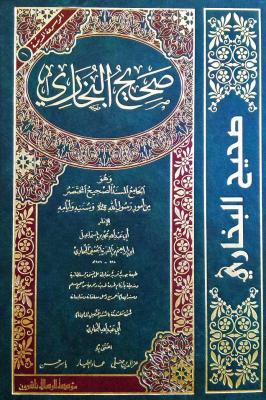حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، قَالَ: (إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثم يبعث الله ملكًا فيؤمر بأربعة: بِرِزْقِهِ وَأَجَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، فَوَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ – أَوِ: الرَّجُلَ – يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ بَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ أَوْ ذِرَاعَيْنِ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا).
قَالَ آدَمُ: (إلا ذراع).
[ر: ٣٠٣٦]
عن النبي ﷺ قال: (وكَّل اللَّهُ بِالرَّحِمِ مَلَكًا، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ نُطْفَةٌ، أَيْ رَبِّ عَلَقَةٌ، أَيْ رَبِّ مُضْغَةٌ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهَا، قَالَ: أي رب، ذكر أَمْ أُنْثَى، أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، فَمَا الرِّزْقُ، فَمَا الْأَجَلُ، فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ).
[ر: ٣١٢]
﴿وأضلَّه الله على علم﴾ /الجاثية: ٢٣/.
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: (جفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاق).
[ر: ٤٧٨٨]
قال ابن عباس: ﴿لها سابقون﴾ /المؤمنون: ٦١/: سبقت لهم السعادة.
قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُعْرَفُ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: (نَعَمْ). قَالَ: فَلِمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ؟ قَالَ: (كُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا خلق له، أو: لما ييسَّر له).
[٧١١٢]
(أيعرف) أيميز ويفرق بحسب قضاء الله وقدره، وهل هم متميزون في علم الله تعالى. (فلم يعمل ..) أي لا يحتاج إلى العمل طالما أن الأمر مقدر. (كل يعمل ..) كل مكلف تتهيأ له الأسباب للعمل بما قدر الله تعالى له، حسب علمه سبحانه بميله واستعداده وما يكون منه. والحاصل: أن المآل محجوب عن المكلف، فعليه أن يجتهد في عمل ما أمر به، فإن عمله أمارة إلى ما يؤول إليه أمره غالبًا. [فتح، عيني]].
سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عن أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: (اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ).
[ر: ١٣١٧]
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: (اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كانوا عاملين).
[ر: ١٣١٨]
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ
⦗٢٤٣٥⦘
يهوِّدانه، وينصِّرانه، كَمَا تُنْتِجُونَ الْبَهِيمَةَ، هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ، حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟ قَالَ: (اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عاملين).
[ر: ١٢٩٢]
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّر لها).
[ر: ٤٨٥٧]
كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إِحْدَى بَنَاتِهِ، وَعِنْدَهُ سَعْدٌ وأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ومُعَاذٌ، أَنَّ ابْنَهَا يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا: (لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلِلَّهِ ما أعطى، كل بأجل، فلتصبر ولتحتسب).
[ر: ١٢٢٤]
أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا وَنُحِبُّ الْمَالَ، كَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أوَإنكم تَفْعَلُونَ ذَلِكَ، لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هي كائنة).
[ر: ٢١١٦]
لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ خُطْبَةً، مَا تَرَكَ فِيهَا شَيْئًا إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا ذَكَرَهُ، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ، إِنْ كُنْتُ لأرى الشيء قد نسيت، فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه.
(لأرى الشيء) الذي أخبر ﷺ عن وقوعه. (قد نسيت) أي ذلك الشيء، وفي نسخة (نسيته).
⦗٢٤٣٦⦘
أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ:
كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَهُ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ، وَقَالَ: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ). فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَلَا نَتَّكِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (لَا، اعْمَلُوا فَكُلٌّ ميسَّر. ثم قرأ: ﴿فأما من أعطى واتقى﴾. الآية).
[ر: ١٢٩٦]
شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ يدَّعي الْإِسْلَامَ: (هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ). فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ مِنْ أَشَدِّ الْقِتَالِ، وَكَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ فَأَثْبَتَتْهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فقال: يا رسول الله، أرأيت الَّذِي تَحَدَّثْتَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، قَدْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَشَدِّ الْقِتَالِ، فَكَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ). فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَرْتَابُ، فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ وَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الْجِرَاحِ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ فَانْتَزَعَ مِنْهَا سَهْمًا فَانْتَحَرَ بِهَا، فَاشْتَدَّ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صدَّق اللَّهُ حَدِيثَكَ، قَدِ انْتَحَرَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (يَا بِلَالُ، قُمْ فأذِّن: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَإِنَّ اللَّهَ ليؤيِّد هذا الدين بالرجل الفاجر).
[ر: ٢٨٩٧]
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِينَ، فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: (مَنْ أحبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا). فاتَّبعه رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، حَتَّى جُرِحَ، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَجَعَلَ ذُبَابَةَ سَيْفِهِ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مُسْرِعًا، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: (وَمَا ذَاكَ). قَالَ: قلتَ لِفُلَانٍ: (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ). وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِنَا غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِينَ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ
⦗٢٤٣٧⦘
عَلَى ذَلِكَ، فَلَمَّا جُرِحَ اسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: (إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجنة وإنه من أهل النار، الأعمال بالخواتيم).
[ر: ٢٧٤٢]
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن النذر، قال: (إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ من البخيل).
[٦٣١٤ – ٦٣١٥]
عن النبي ﷺ قال: (لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذر بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُه، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ الْقَدَرُ وَقَدْ قَدَّرْتُه له، أستخرج به من البخيل).
[٦٣١٦]
(يلقيه القدر) إلى ما نذر من أجله.
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَجَعَلْنَا لَا نَصْعَدُ شَرَفًا، وَلَا نَعْلُو شَرَفًا، وَلَا نَهْبِطُ فِي وَادٍ إِلَّا رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا بِالتَّكْبِيرِ، قَالَ: فَدَنَا مِنَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أصمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا). ثُمَّ قَالَ: (يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ، أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَةً هِيَ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ).
[ر: ٢٨٣٠]
﴿عاصم﴾ /هود: ٤٣/: مانع. قال مجاهد: ﴿سدًا﴾ /يس: ٩/: عن الحق، يترددون في الضلالة. ﴿دسَّاها﴾ /الشمس: ١٠/: أغواها.
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَا اسْتُخْلِفَ خَلِيفَةٌ إِلَّا لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وتحضُّه عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وتحضُّه عَلَيْهِ، وَالْمَعْصُومُ مَنْ عصم الله).
[٦٧٧٣]
﴿أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلا مَنْ قَدْ آمَنَ﴾ /هود: ٣٦/. ﴿وَلا يَلِدُوا إِلا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾ /نوح: ٢٧/.
وَقَالَ مَنْصُورُ بْنُ النُّعْمَانِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: وِحرْمُ بالحبشية وجب.
ما رأيت شيئا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ، مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (إن الله كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تمنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يصدِّق ذَلِكَ أَوْ يكذِّبه). وَقَالَ شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبي ﷺ.
[ر: ٥٨٨٩]
﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلا فِتْنَةً للناس﴾. قَالَ: هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ، أُرِيَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: ﴿وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي القرآن﴾. قال: هي شجرة الزقُّوم.
[ر: ٣٦٧٥]
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (احتجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خيَّبتنا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ، قَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ، وخطَّ لَكَ بِيَدِهِ، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قدَّره اللَّهُ عليَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟ فحجَّ آدَمُ مُوسَى، فحجَّ آدَمُ موسى). ثلاثًا.
وقال سفيان: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثله.
[ر: ٣٢٢٨]
(خيَّبتنا) أوقعتنا في الخيبة وهي الحرمان. (خط لك بيده) أنزل عليك كتابه التوراة. (أربعين سنة) مدة لبثه طينًا إلى أن نفخت فيه الروح. (فحج) غلبه بالحجة. (ثلاثًا) كررها ثلاث مرات. قال النووي: معناها إنك تعلم أنه مقدر، فلا تلمني. اهـ وأيضا: اللوم شرعي لا عقلي، وإذا تاب الله عليه وغفر له ذنبه زال عنه اللوم، فمن لامه كان محجوجًا.
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ خَلْفَ الصَّلَاةِ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ
⦗٢٤٤٠⦘
ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ).
وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ: أَنَّ ورَّادًا أَخْبَرَهُ بِهَذَا. ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدُ إِلَى مُعَاوِيَةَ، فَسَمِعْتُهُ يأمر الناس بذلك القول.
[ر: ٨٠٨]
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفلق. من شرِّ ما خلق﴾ /الفلق: ١ – ٢/.
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وشماتة الأعداء).
[ر: ٥٩٨٧]
كَثِيرًا مِمَّا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْلِفُ: (لا ومقلِّب القلوب).
[٦٢٥٣، ٦٩٥٦]
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِابْنِ صَيَّادٍ: (خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئَا). قَالَ: الدُّخُّ، قَالَ: (اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ). قَالَ عُمَرُ: ائْذَنْ لِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، قَالَ: (دعه، إن يكنه فلا تطيقه، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قتله).
[ر: ١٢٨٩]
قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿بِفَاتِنِينَ﴾ /الصافات: ١٦٢/: بمضلِّين إلا ما كَتَبَ اللَّهُ أَنَّهُ يَصْلَى الْجَحِيمَ. ﴿قدَّر فَهَدَى﴾ /الأعلى: ٣/: قدَّر الشقاء والسعادة، وهدى الأنعام لمراتعها.
أَنَّهَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُونِ، فَقَالَ: (كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، مَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ فِي بَلَدٍ يَكُونُ فِيهِ، وَيَمْكُثُ فِيهِ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَلَدِ، صَابِرًا مُحْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شهيد).
[ر: ٣٢٨٧]
﴿لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ من المتقين﴾ /الزمر: ٥٧/.
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ، وَهُوَ يَقُولُ:
(وَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا … وَلَا صُمْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا … وثبِّت الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا
وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا … إذا أرادوا فتنة أبينا).
[ر: ٢٦٨١]
 أخبار تونس نور العقيدة، أساس العلم، وحقائق الكون !
أخبار تونس نور العقيدة، أساس العلم، وحقائق الكون !